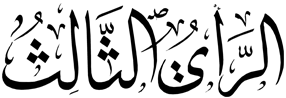استذكار عبدالعزيز المقالح: الشعر والمحبة والحياة
استذكر اليمنيون ومعهم المثقفون العرب شاعرهم ومواطنهم الفذ عبدالعزيز المقالح في ذكرى غيابه الثالثة. صنعاء التي أحب ولازمها سكناً وملاذاً ومكانَ قصيدةٍ وذكرياتٍ وجراحٍ كثيرة وأمل قليل، آثرت أن تستذكره عبر الشعر، فخصص أصدقاؤه وقراؤه وطلبته ومواطنوه مهرجاناً شعرياً يحمل اسمه.
الشعر يوحد الفرقاء ويضع الكلمة فوق الاعتبارات الطارئة. والشعر وحده كان سلاح المقالح الذي يعرف كل من قابله أو عايشه أنه رمز للسلام والمحبة. لم يخذل أحداً، حرص على أن يكون اليمن في قلب العصر لا على هامشه.
رسالة يبدو أنها لا تتحقق إلا بضرب من الكفاح الحقيقي، عقد المقالح العزم على تبنّيه ومواصلة طريق التجدد والتحديث،
في القصيدة التي كان رائد انتقالها من الكلاسيكية المزمنة في الخطاب الشعري إلى الحداثة التي لم يضع لها حدوداً، وارتضاها (متوازنة) كما لخّص الشاعر السوري الراحل إبراهيم الجرادي في عنوان كتاب حرّره عن المقالح.
وراح يزاوج النثر والوزن في كتاباته الشعرية الأخيرة. وفي الحياة أيضاً انصرف المقالح لنشر المعرفة عبر التعليم في يمن خرج من ظلمات الإمامة وجمود الوقع وتكلس التخلف وانتشاره.
أسهم في توسيع الجامعات لتصبح في المحافظات اليمنية كلها، وأنشأ معاهد وكليات في المدن النائية مفسراً ذلك بأنه خير ما يمكن فعله للانتقال إلى العصر والعيش في متنه.
لم يكن المقالح شاعراً فئوياً انعزالياً. فله عبر صداقاته العربية وتعليمه الأول ودراساته ومساهماته الشعرية والنقدية ما يربط الثقافة اليمنية بالأفق العربي.
ولعل من المكرر قولنا إنه استضاف التدريسيين والأدباء والشعراء العرب من شتى بلدانهم وإقاماتهم، ليُغنوا المشهد التعليمي والأدبي.
كان المقالح مثالاً لمثقف عضوي لا يرتفع سقف رؤيته بحيث لا يرى واقع بلاده وآمالها وخساراتها. ولا يتواطأ مع الصمت أو يرضى بالسكون والتجاهل. لكنه نأى بنفسه شاعراً ومواطناً عن التحزب والاقتتال والانتماءات الخارجة عن مرمى غرضه ورسالته.
لذا اجتمعت محبة اليمنيين عليه أيقونةً لم يلحقها صدأ أو خرق أو خلاف. حتى حين اكتوت بلاده بالحرب المستمرة والتي لا يبدو لها أفقُ نهاية، لم يرض المقالح إلا بأن يكون صوت سلام وعقل وسط الاحتراب الدامي والتمزق.
لكن ذلك انعكس على طاقة مقاومته وقدراته ومديات صبره، فركن إلى يأس وحزن كبيرين، رصدته قصائده في أخريات حياته.
لم يكن يطلب من الشعر والقصيدة إلا أن يكونا صوت الفقراء والمتعبين والمهمشين في أوطاننا المنطوية بشتى الأعراض والوقائع.
وقد أحسن معدّو الاحتفاء بالمقالح إذ وضعوا في إشهار الفعالية الاستذكارية مقطعاً شعرياً للمقالح يتحدث فيه عن قصيدة لا تلبي جوع الجائعين أو تسد العوز،
وهو مجتزأ من قصيدة فهرستُها في دراستي للميتاشعري ضمن القصائد التي تتأمل نفسها وتستجلي أفق تلقيها، وتفصح عن خيبة إذ ترتطم بأرض الجائعين والمعانين من الظلام والحرب والفاقة:
«هطلت على الناس القصيدةُ
بعد صمت باذخ
خرجتْ إلى اللا وقت
أصبح وقتها كل النهار إذا أراد الناس
أو كل المساء إذا أرادوا
لكنها اصطدمت بأول قارئ
يشتاق قبل الشعر للثوب النظيف
عبثاً تحاول أن تكون قصيدة
في عالم أعمى
يجوع إلى رؤى المعنى
ويحلم بالرغيف!».
لكن المقالح لم يفقد إيمانه بالقصيدة وسيلة لبثّ معاناته وأهوال الحياة التي قدر له أن يحياها: قادماً من قرية نائية في ريف إب، وقد أرانا في إحدى الزيارات لقريته تلك المسافة الطويلة التي كان يقطعها صغيراً مشياً ليصل إلى المدرسة.
كما صحب أباه فترة في السجن في عهد الإمامة.
وهاجر دارساً في السودان، ثم في مصر التي شهدت تفتح وعيه وتطوير اهتماماته بالشأن العربي، فكانت أشعاره تسجل الأحداث الكبرى بدءاً بنكبة احتلال فلسطين حتى الانتكاسات الجارحة في حزيران وما تلاها.
كل ذلك شكّل مزاج المقالح الهادئ المنطوي في الظاهر، والمحتشد في الداخل ضاجّاً بالشكوى مما يراه من وقائع وأحداث..
كان في منهجه الشعري مجدداً يستعين بالرمز والأسطورة والأقنعة لتوصيل دلالات قصائده، ومراميها المندرجة في هموم شعبه والعرب والعالم أيضاً. كتب الكثير شاهداً معذَّباً على المشهد المأساوي والتدهور الذي آلت إليه الأوضاع كلها.
لكنه، متمسكاً بوعيه وقصيدته وحلمه، ظل منافحاً عن الغد الذي لم يقيض له أن يراه، فرحل وهو يرى توالي التراجع في الحياة والحريات والحقوق، وتفاقم مآسي الفقراء وازدياد احتياجاتهم للمقومات التي تقتضيها الحياة.
استنطق شخصيات تاريخية يمنية وعربية وجعلها أقنعة ورموزاً في قصائده؛ كسيف بن ذي يزن وبلقيس ووضاح اليمن وعلي ابن الفضل وابن زريق البغدادي ومالك ابن الريب وغيلان الدمشقي وعمارة اليمني والمعري، وعوليس وبنلوب وبروميثيوس ودون كيشوت… انطلاقاً مما ذكره في دراساته النقدية حول الأداء الرمزي وكونه (فتح أبواباً للشعر لم تكن من قبل، أو كانت في نطاق ضيق). ويصفه بأنه ذروة تطور الأسلوب الشعري المعاصر.
وفي قصائد القناع حافظ المقالح بموازنة فنية جيدة على ما يدعوه إحسان عباس رقة القشرة الدرامية أو رقة الحاجز بين الأصل القناع ودقته. فكان يجلب الشخصية إلى عصرنا، بدون أن يلوي حقائق وجودها في الأصل أو يحرّفه إلا بما يسقطه عليه من وعي.
فهو يستطرد مثلاً من مأساة أو لغز موت وضاح اليمن ودفنه حيّاً، إلى استبطان أحاسيس حبيبته روضة ويقترب بها من عصرنا لتقول: (من أنتَ؟ ما تبتغي من فتاة عجوز بلا زاد،
أسلمها قومها للمجاعة والموت، باعوا ضفائرها حبالاً، وناموا على عتبات المواعيد يقتسمون كؤوس المهانة في الحلم، يختصمون على القيد، يحتطبون بوادي الثعابين، يستمطرون الإله العقيم).
إن تلك الشكوى تؤول نقديا وعبر القراءة المدققة بأنها تحيل إلى ما آلت إليه الأوطان، وما هيمن عليها من هوانٍ وذل وخوف وجشع.
وهنا نتوقف عند الجهد النقدي المحايث لكتابة الشعر. فقد أوقف المقالح دراساته على أبرز قضايا التجديد والمعاصرة،
رغم أنه بدأ دراساته العليا ببحث مهم عن الفنون الشعبية الشعرية في اليمن وشعر العامية بوجه خاص. لكنه سيعاين الشعر اليمني والعربي بمنظار التجديد ويستحضر فكر من أسماهم في أحد كتبه (عمالقة عند مطلع القرن)، ثم ينحو صوب الشعر المعاصر،
فيقدم عدة دراسات معمقة في طليعتها اهتمامه بشعر الشباب في اليمن الذين سلط ضوء القراءة النقدية في كتابه «بدايات جنوبية»، على تجاربهم، وهم في مقتبل العمر الشعري، مانحاً بدراسته تلك ثقة وأملاً لهم في تجديد القصيدة والانطلاق في فضاء الحداثة.
ويحسب للمقالح تلك الحرية المنهجية التي منحها لنفسه ناقداً وباحثاً، فلم يرهن جهده وتوصلاته بمنهج محدد ضيق، وإن اقترب كثيراً من الانطباعية واستقراء الظواهر الفنية والجمالية في الشعر والرواية.
وأتاح له ذلك ان يعاين النصوص من زوايا مختلفة تفرضها غالباً المهيمنات التي تبدو على أبنيتها.
لقد اقترن كل حديث عن المقالح في ما كتب عنه بالجانب الإنساني فيه. وهو ليس حديثاً عن طبائع وخصال نفسية فحسب، بل إشارة لكتاباته ومؤلفاته ومواقفه الحياتية والثقافية الملتزمة والصريحة.
ويكفي مثالاً على تلك الإنسانية والصفاء النفسي ما ضمّه كتابه الشعري «كتاب الأصدقاء» الذي جعل له عتبة أولى اقتبس فيها كلمات لأكتافيو باث من كتاب «اللهب المزدوج» تقرن الصداقة بالحب بكونهما عاطفتين متكاملتين متقابلتين.
وفيها يرى أن الصداقة لا تولد من نظرة، ولكن من شعور أكثر تعقيداً مثل التشابه في الميول والأفكار والمشاعر. فكتب المقالح قصائد تشبه البورتريه لعشرات ممن صادقهم والتقاهم وتعلم منهم،
وأردف كل نص بمجتزأ من شعرهم وكلماتهم. ولعله بذلك يعلي من قيمة الصداقة والصديق وموقعه في النفس، في سابقة لم تحدث كثيراً. وتظل علامةً على نًبلٍ فريد وخُلق يليق بشاعر ينزه الشعر والشعراء، ويرنو إلى إنجاز رسالة تلازم مفهومه للشعر، وقدرته على تغيير العالم إن توفرت ظروف مساعدة، كثيراً ما كان المقالح يتألم لأنها لا تحصل غالباً.
بهذا وسواه الكثير حقَّ للمقالح علينا استذكاره بالمحبة ذاتها التي سوّرت تجربته وأفردته بين معاصريه، ورسخته حياً في الذاكرة والقلب والضمير.
حاتم الصكَر